
1904 مشاهدة
0
0
إن ديننا يزن الأعمال بمثقال الذرة لا يقبل الفوضى الهائلة التى تقع بين الناس، سواء كانوا مسلمين، أم كانوا يهوداً أو نصارى، من كتاب الطريق من هنا للكاتب محمد الغزالي
كتاب : الطريق من هنا - تأليف : الشيخ محمد الغزاليالحلقة [ 6 ] : أمة بخير يجب أن تؤدى رسالتها
بعد النومة الطويلة أو الاغماءة الطويلة التى أصابت المسلمين فى الأعصار الأخيرة، جاءت يقظة مرجوة الخير، وشرع العامة والخاصة يمسحون عيونهم ويحركون أعضاءهم ويعملون على استئناف المشوار العتيد!.
ونظرت إلى أمتى ترمق المستقبل بأمل، وتنشط كى تتقدم وتزاحم وتسبق، ولكنها لا تتقدم خطوة حتى تحاصرها العقبات، وتقفها المتاعب! والمحزن أن هذه المتاعب من عند نفسها أكثر مما هى كيد العدو وسعيه لهزيمتها..!.
لقد شعرت بأن أمتنا نسيت رسالتها، أو جهلت هذه الرسالة من زمان بعيد، إن هذه الرسالة من وضع الله لنا لا من مزاعمنا لأنفسنا، أو دعاوانا لجنسنا..!.
والأمة التى لا تعرف لها هدفا قد تتحرك فى موضعها، أو تتحرك فى اتجاه مضاد، أو تصيب نفسها وهى تريد إصابة غيرها، إن الطيش يحكمها لا الرشد!.
وقد حدد القرآن الكريم رسالتنا فى هذا العالم فقال: ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) أهى دعوة نظرية إلى الخير فى الملصقات والكتيبات والنشرات العامة؟؟ لا، يجب أن تقدم الأمة من نفسها نموذجا حيا أو أسوة حسنة لما تدعو إليه ( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون * وجاهدوا في الله حق جهاده ).
إن عمل الخير والدعوة إلى الخير، سمات الأمة الظاهرة، وملكاتها الباطنة، ووظيفتها الدائمة، وشهرتها التى تملأ الآفاق، وإجابتها عندما تسأل عن منهجها وغايتها (وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا).
وما ينتظر من أمة تحمل رسالة السماء وتتبنى دعوة الحق إلا أن تكون حارسة للشرف، مترفعة على الدنايا، متواصية بالمرحمة، منظورا، إليها محليا وعالميا بأنها سند المظلوم وجار المستضعف، ويجب أن تكون قديرة على ذلك وسمحة به!!.
وقد بين الله أن الأنبياء ـ وكذلك أتباعهم ـ ليسوا باعة كلام ولا أدعياء فضل بل هم كما شرح فى كتابه (وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين).
فهل تولت أمتنا هذا المنصب؟ أو هل تأهلت له بفقهها ومسلكها؟ أم زاحمت غيرها على طلب المتاع والتعلق بالدنيا؟ الذى يبدو لى أن المسلمين شعوبا وحكومات- هبطوا دون المستوى المنشود، بل هبطوا دون مستوى غيرهم ممن لم يشرفهم وحى، ويكلفوا بحمل رسالة!.
والمرء قد يمشى الهوينى غير آبه لما أمامه إذا كان خالى البال لا يشغله واجب محدد ، أما إذا كان فى سباق مهتم ومع أنداد قادرين أو خصوم قاهرين فإنه يحث الخطى ويجمع العزم ويتجاوز العقبات..
والمسلمون منذ بدأوا تاريخهم ما صفا لهم الجو، ولا خلا لهم الطريق..! فكل استرخاء أو تخاذل سيستغله شياطين الإنس والجن للنيل من الحق وتركه فى المؤخرة والانفراد دونه بالصدارة..
وهذا ما وقع فنحن المسلمين الآن فى العالم الثالث على حين أمسك بزمام الحضارة من ينكرون الألوهية أو من يتخيلونها " عائلة مقدسة "..
وهم لم يعوقونا عن الانطلاق فى أغلب مراحل تخلفنا، بل نحن الذين فرطنا وتكاسلنا، وتركنا المجال فسيحا أمام غيرنا فمد لما أخليناه.
إن عناوين الخير والمعروف- وهى معالم رسالتنا- لم تساندها حقائق قائمة، فكانت النتيجة أن تلاشى صدى هذه الكلمات النبيلة، فاختفى وقعها من نفوس السامعين، وظنت أمم كثيرة أن المسلمين طلاب شهوات أو قطاع طرق، وأنهم يوم يملكون القوة . يسخرونها لإعلاء جنس، وتحقيق أمجاد وطنية أو قومية، وهذا كله إفك! بيد أن المسئول عن انتشار شائعاته أصدقاء جهلة أو عجزة، كما يحمل المسئولية أيضا أعداء مرجفون مريبون.
تدبرت هذه الآية (قل إنما أنذركم بالوحي) والآية الأخرى (فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا) فرأيت أن صاحب الرسالة لا يفتح العقول بسكين إنما يفتحها بكلمات الله المنيرة التى تنزلت عليه، وأنه منهى عن طاعة الكافرين مأمور أن يجاهد بهذا القرآن من تنكروا له واعترضوا سيره...
وأعلم بدراستى وتجربتى معا أن هناك مستكبرين يستبيحون غيرهم ويجتاحون حقوقه المادية والأدبية، وأن الاستسلام لهؤلاء وضاعة، وترك الحقيقة تداس تحت أقدامهم جريمة! إن هؤلاء لابد من مقاومتهم وحشد أهل اليقين لحسم شرهم!.
فى هؤلاء يقول الله لنبيه: (فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا).
تدبر هذا السياق، وكيف أبرز عدوان المعتدين، وكيف يستعان بالله على كفكفة شرهم، وكسر بأسهم! إن المؤمنين يلقون هجوما فلا يجوز لهم أن يفروا أمامه! ومن أجل الله وفى سبيل الله يتحملون أعباء هذا التصدى.
إننا لم نبدأ عدوانا، لقد أنذرنا بالوحى، وجاهدنا بالكلمة، وشرحنا بغيتنا وهى تحقيق الخير والمعروف فى الدنيا، وتحويل الأرض- حيث قدرنا- إلى ساحات عبادة لله وتراحم بين عباده لا يدع فى المجتمع جائعا ولا عاريا ولا محروما ولا محقورا...
تلك أهداف أمتنا كما رسمها القرآن الكريم (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر).
لكن المأساة الكبرى أن هذا الهدف نسيه من فيه، ولم يشغل نفسه ولا قومه بالإعداد العلمى الواسع له، ولم يكلف نفسه محو الشبهات التى أثيرت عمدا حول مقاصده.
فمضت الأمة فى طريق ملىء بالغيوم، وأخذت تقاتل دون أن يكون بين يديها عرض جيد للحق، وتطبيق أجود لمبادئه، وكنت أقرأ وأنا طالب أن علاقتنا بغيرنا هى الإسلام أو الجزية أو الحرب!!!!.
إن الذى أرسل هذا الكلام على عواهنه نسى الوظيفة الأولى للأمة، وهى الدعوة السليمة وإرسال أشعة كاشفة عما تريده للعالم من رشد وسعادة..
قد يدهش امرؤ لهذا القول ويرد على عجل: كان آباؤنا يَدعون إلى عقيدة التوحيد ويستندون فى جدالهم عنها إلى مواريثهم من كتاب وسنة، فلا عذر لأحد.
ونمضى نحن فى توضيح ما نعنى! إن عقيدة التوحيد جذع شجرة باسقة مزهرة مثمرة لها سبعون غصنا، أو سبعون شعبة يلتمس الناس تحتها الظل والجنى، لماذا جعلنا هذه العقيدة خشبة جرداء لا تغرى أحدا أن يأوى اليها؟ لماذا ترك المجال مفتوحا أمام الأعداء يزعمون أنها شجرة شوك لا زهر فيها ولا ثمر؟.
إن الخاصة الأولى للأمة الخاتمة أنها غيورة على الحقيقة، لا تطيق تشويهها ولا إغفالها، ومن ثم فهى لا تسكت عن أمر بمعروف أو النهى عن منكر فإذا بليت هذه الأمة بسلطات تكمم الأفواه، وتدع العامة والخاصة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فهل هى بذلك الصمت الجبان تبلغ رسالة الله؟ أم هى تقطع الطريق إليها..
لقد أخذ الأحرار على ملك فرنسا لويس الرابع عشر أنه قال: أنا الدولة! يعنى أنه وحده المسئول عن شئونها لا شريك له.
فإذا كان " السلطان " فى بلاد الإسلام يردد بلسان الحال أو المقال هذه الكلمة، فما الفرق بين دولة الإيمان ودولة الكفر، وأين يجد الناس ساحة المساءلة والشورى، والأخذ والرد دون تهيب ولا توجس؟؟.
إن العقيدة الإسلامية أساس حضارة راشدة راقية ولا يسوغ أن يتدرع بها من يخدمون مآربهم وأغراضهم، ونحن مكلفون بتبليغ رسالة نازلة من السماء لا حمل أوضاع من صنع الناس.
أعرف ويعرف غيرى أن الإمامة العظمى فى الإسلام احتكرتها ثلاث أسر خلال اثنتى عشر قرنا، أفلمصلحة الإسلام وعلى هدى تعاليمه تم هذا؟ قد نقول: إن هذا الخطأ لم يؤثر على حقيقة الدين أو على مساره، وهذه إجابة تتطلب وقفة طويلة وشرحا مستفيضا، لا سيما أن ركام الأخطاء الذى آل إلينا على مر القرون جعل المسلمين المعاصرين يضطربون فى الفهم والمنهج، بل جعلهم يظنون أن الحكم من نوازل القدر التى لا ترد، وأن استقباله كاستقبال الآفات والمصائب الوافدة يكون بالصبر والاسترجاع!.
وقد أورثتهم هذه الجبرية الخرافية استسلاما واستكانة لضروب الحكم الاستبدادى قلما يعرفان فى جنس آخر...!.
إن الدولة صاحبة الرسالة تكرس قواها المادية والأدبية فى الداخل والخارج لإنجاح رسالتها وشرح حقائقها على نحو رائق جذاب، وليس يجديها زخرف القول إذا كانت صورتها الداخلية دميمة، إذ الناس بعد التروى والتأمل يعولون على الموضوع لا على الشكل..
والوظيفة الأولى لدولة الإسلام أن ترى الأمم الأخرى آفاق الخير الذى تدعو إليه مشرقة فى حياتها هى! فى أخلاقها وتقاليدها وعباداتها ومعاملاتها وآدابها وفنونها وملاهيها وأسواقها وقراها ومدنها، أى فى جميع أنشطتها التى تكشف عن أعمالها وآمالها..
إننا ـ باسم الإسلام ـ ندعو إلى الخير ونفعله، فما وزن هذه الدعوى العريضة وما آثارها؟.
إننى أقرر مطمئنا أننا لم نحسن تبصير الجماهير الهائمة فى شتى القارات، وليست لدينا أجهزة قديمة قائمة من قرون على البلاغ المبين، والذين اختطفوا مناصب الإمامة العامة حقبا مديدة كانوا أنزل رتبة من أن ينهضوا بهذا العبء!.
إنهم لم يكونوا عالمين، ولم يكن للراسخين فى العلم مكانة لديهم.. وقد حسب لفيف من العرب أن الإسلام ثروة قومية يمكن أن ينتفع بها الجنس العربى ـ كثروة النفط مثلا ـ فتركوا الإسلام يتمدد بقواه الذاتية وبالجهود الشعبية، وانشغلوا هم بمراسم الحكم ومطالبه..
فلما وقعت الخلافة فى يد الأتراك بدأوا بداية حسنة فى خدمة الإسلام ثم انتقلت اليهم علل الخلافة العربية فضاعوا وأضاعوا..
وطلع علينا هذا العصر الكئيب، فإذا رايات الإسلام تطوى علانية تحت شعارات العروبة التى تعد محمدا بطلا قوميا (!) وأمام زحف الملل والفلسفات الأخرى التى خلا الجو لها فباضت وأفرخت..
تلك خسائر فادحة نزلت بأمتنا ورسالتنا، والعلاج أن نعرف: من نحن؟ وما رسالتنا؟ وكيف نؤديها؟ وكيف نتخلص من أخطائنا؟ وكيف نستفيد من تجارب النصر والهزيمة، والمد والجزر...
ولنعلم أن عباد الله فى المشارق والمغارب ليسوا مستعدين أن يتبعوا قيصرا جديدا يلبس عباءة الإسلام، وأن علماء الدين الذين يشغبون على الشورى ليسوا علماء ولا متدينين، إنما هم قذى تجب تنحيته عن الطريق...
وأعرف أن الاستبداد السياسى عاد إلى المجتمعات من الباب الخلفى فى شكل تنظيمات دستورية مزورة! والحقيقة لا تخفى وراء هذه الألبسة الخادعة مهما تراكم حولها ذباب المنتفعين والمنافقين...
الإسلام وأمته أكبر من هذه المظاهر! ولن يصدق الناس أننا رجال أحرار، ننحنى وحسب أمام الواحد القهار، ما بقيت صفوفنا يتقدمها قزم تغضى أمامه العيون، وتخرس الألسنة لأمير ما...!.
وفى عصرنا هذا تتودد المذاهب الأرضية إلى الناس بكفالة ضروراتهم البدنية، وإشباع نهمتهم منها! والإنسان بطبيعته يكره ذل الحاجة، ويضيق بكبت لا نهاية له، ويتعلق بأى نظام ييسر له الضرورات، ويعده أو ييسر له بعض المرفهات...
هل تجهم الإسلام لهذه الطبيعة البشرية؟ إن إيراد السؤال على هذا النحو خطأ! هل لم يسارع الإسلام إلى كفالة هذه الحقوق البشرية؟.
فى صدر حياتى ألفت بضعة كتب شرحت تلك القضية، كنا ـ أنا وسيد قطب، ومصطفى السباعى ـ نذود الجماهير المتطلعة عن اعتناق الشيوعية، لأن بريقها استهواهم، فقدمنا البديل من تعاليم الإسلام..
وإنما استهوى الناس هذا البريق لأن فوضى التملك من حرام تسربت إلى أغلب الأموال، ولأن تبلد المشاعر بإزاء الآم المحرومين قطع أوصال المجتمع، وبعثر فى أكنافه بذور الحقد!.
وكثير من المشتغلين بالثقافة الإسلامية يحسبون أن الإسلام بعدما قضى على الأصنام فى الجزيرة العربية قد أدى الرسالة وبلغ الأمانة وليعش الناس حسب ما يرغبون من الناحيتين الاقتصادية والسياسية ففى الأمر متسع وليكن ما يكون..!!.
وهذا الجهل الفاضح أثقل الأفكار والأقدام، وأحكم حولها القيود فكانت العاقبة أن وثب العالم إلى الأمام بخطوات فساح، وضبط شئون الحكم والمال وفق ما يرى مصلحته، أما المسلمون فوقفوا أو تخلفوا، ومن أراد بهم خيرا حاول إلحاقهم بقطار الشرق أو الغرب، لأنه لا يعرف حقيقة الدين من رجال قاصرين، ومن هنا توجب على الحكومة الإسلامية أن ترقب سير المال فى الحياة العامة، وأن تدرك خطورة انحرافه أو طغيانه على العقائد والأخلاق..
ولا أجد أى حرج فى اقتباس ما استحدثه البشر من أنظمة ووسائل حماية الفرد من طغيان الاستبداد أو رأس المال..
والواقع أن العصور الحديثة لها اجتهاد مثمر ناجح فى تنظيم الشورى، وفى إدارة الأعمال، وفى حماية الفقراء والكادحين...
ونقل هذه الوسائل إلى بلاد الإسلام ليس بدعة ضلالة كما يزعم المتدينون الجهال، بل تكاد تكون واجبا حتما بعد عهود التخفف والضياع التى رانت علينا..
ومن السفه استبقاء الشورى فى طورها الساذج أيام سقيفة بنى ساعدة واستبقاء العطاء يدا تدفع ويدا تأخذ وحسب!.
إن العمران البشرى اتسعت دائرته وتعقدت أحواله، وعلينا مواجهة ما جد بأقضية ذكية مجدية، وما فكرنا يوما فى تعطيل نص، أو الشذوذ عن قاعدة، وإنما سعينا إلى تجاوز عصور الانحطاط والهزيمة التى طال ليلها، مستندين إلى مواريثنا المحفوظة وحدها...
ومن واجب الدولة ضبط العلاقات بين الجنسين داخل إطارها الصحيح، فإن ذوى الفطر السليمة ضاقوا بالتبرج الجاهلى الذى يصحب الحضارة الحديثة، وما انتهى إليه من انحدار وتهتك..
وقد قلنا: إن العجز الفكرى والنفسى عند لفيف من المتدينين من وراء هذا التطرف الحيوانى الكاسح! فهم لا يفهمون المرأة إلا وسيلة متعة خاصة، وينكرون عليها إنضاج ملكاتها الروحية والعلمية، ولا يعون أن لها أى حصة فى ميادين التربية وآفاق المجتمع، وخدمة الدين والدولة..
وقد أعيانى الحديث مع شباب يوجب تغطية وجه المرأة ويديها ويحرم عليها الجمع والجماعات، ويذهب إلى جملة من المرويات الشاذة أو المنكرة كى ينزل الدين على رأيه! قلت لهم: إن عملكم هذا سيجعل النهضة النسائية تزيغ عن الدين، وتلهث وراء الغرب.
وعندما تقولون: لابد من ضرب النقاب على الوجه فسوف يسحب النساء الخمار عن الرءوس، وعندما تقولون: لا بد من تخبئة الأيدى داخل قفاز فسوف تتعرى السواعد والأيدى جميعا، إن الغلو يستتبع الغلو، إنكم تكذبون على الإسلام من جانب وهن يكذبن على الإسلام من جانب آخر، وكلاكما شر من صاحبه!.
وأرى أن تدخل الدولة فى موضوع الزواج، وتكوين الأسر، فإن النفاق الاجتماعى وتقاليد الرياء جعلا من عقد الزواج شيئا يقصم الظهور، ويستدعى التريث والإرجاء، وإلى أن يتم بعد لأى يقع فى صمت وخفاء ما يندى له الجبين، وما لا يقبله دين!!.
وثم أمر جدير بالإبراز والإثارة! إن السياسة الفاسدة تبقى وتنمو فى جو الثقافة الفاسدة، وهى إذا لم تجدها سعت لخلقها واحتضان رجالها..
وأرى أن كثير من المعارف المسمومة، والفتاوى الكاذبة، والأحكام الطفيلية، قد عاشت وغلظت فى حضانة الحكم الفردى والاستبداد السياسى، وقد لاحظت أن جماهير المسلمين خلال عدة قرون احتبست فى مجادلات لا تساوى قلامة ظفر، وهاجمت أعصابها فى خلافات محمومة لا طائل تحتها...
وذلك فى وقت كانت رقعة الإسلام تنكمش، وأعداؤه يشتدون وشئونه العظمى يبت فيها التافهون...
إننى شعرت بأن هذا مراد، وإذا لم يكن مخططا فقد تم لمصلحة الطاغين الذين يعنيهم أن تنشغل الأمم عنهم وعن مباذلهم.
وفى عصرنا هذا تقوم شتى الفنون، والألعاب الرياضية بما يشبه هذا الدور..
ولا أدرى لماذا تهتاج أمة لهزيمة رياضية ولا تهتز لها شعرة لهزائمها الحضارية والصناعية والاجتماعية؟؟.
والحكم الإسلامى فى قرون خلت لم يرتفع إلى مستوى الإسلام نفسه، فلا عجب إذا فشل فى تبليغ رسالته وفى الدفاع عنه عندما تعرض له الأزمات..
وقد رأينا الخلافة العباسية فى الزحف الصليبى الأول، لقد عجزت عن حشد طاقات الأمة بل عن جمع صفوفها، فإذا الحملات القادمة من الغرب تعوم فى دمائنا، لا يردها راد! وبقيت الخلافة الواهنة تترنح حتى ماتت تحت أقدام التتار المتعاونين مع الصليبية فى السر والمسلمون لا يدرون!.
وتكررت المأساة نفسها مع الخلافة العثمانية، حذوك النعل بالنعل! ونجح الاستعمار الصليبى الثانى فى نبذ الخلافة العظمى (!) والخليفة المسكين، نبذ النواة. ودفعت جماهير المسلمين من دمها ومن كرامتها ثمن فساد السياسة والثقافة فى عالمنا الإسلامى المريض!.
وقد تحدثت عن هذا التاريخ بشىء من التفصيل فى كتابى " الدعوة الإسلامية تستقبل القرن الخامس عشر " وما كررت الإشارة إليه هنا إلا لأنى رأيت أناسا يعملون فى الحقل الإسلامى لا يعلمون معاقد الدين، ولا غاياته العظمى، وهم يجتهدون فى استحياء العلل القديمة، يحسبونها أسباب نهضة وما دروا أنها أسباب البوار..!!.
إن الدولة الأمينة على الرسالة الإسلامية عليها واجبات ثقيلة نحو الأمة التى تقوم على شئونها، ونحو الأجيال الناشئة التى تقوم على تربيتها يمكن إجمالها فى النقط الآتية :
( أ ) تجديد علوم الدين، وتبصير طلابه بالحقائق الرئيسية، وتجاوز القضايا والخلافات التى خلقها الفراغ والترف فى بعض الأزمنة، وبيان ما هو قطعى وما هو ظنى، وما هو أصلى وما هو فرعى، وتناول المذاهب المختلفة على أنها وجهات نظر ليست معصومة من الخطأ..
إن تدريس الدين الآن بحاجة إلى إعادة نظر! فهناك معلومات تقدم للكبار فقط تشحن بها عقول الصغار، وهناك آراء للرجال تقدم على أنها وحى معصوم أو نص ثابت! وهناك أركان للأخلاق والسلوك تراجعت لتحل محلها صور فقهية ثانوية!.
(ب) إن العناية بالتربية تتطلب محو الخصومة القائمة بين الفقهاء والصوفية على أساس تجريد التصوف من البدع والخرافات التى التصقت به، ورده إلى كتاب الله وسنة رسوله ردا يدرب الناس على مقام الإحسان، أعنى مراقبة الله ومشاهدته..
إن الإنسان لا يرقى أبدا بعقله وحده، فكم من ذكى العقل غزير العلم تراه خبيثا لا تؤمن أطماعه، وكم من منافق عليم اللسان.
وأعرف أن عددا من المنتمين إلى التصوف دعى لا ضمير له، غير أن هذا لا يزهدنا فى تعهد القلوب بما فى هذا العلم من حكم ثمينة، وتجارب رقيقة...
ولست أحب أن ينفصل العلم عن التربية الروحية، ولا أن تنفصل التربية الروحية عن العلم فلا قيمة لأحدهما دون الآخر.
(جـ) جماهير المسلمين فقيرة إلى تدريب مستمر على الشئون المدنية، وهى بحاجة ملحة إلى مهارات كثيرة فى ميادين الحياة العملية، وتخففها فى هذا المضمار يهزم الإسلام وينال من قدرته على قيادة الناس.
وإنه ليحزننى أن يكون المسلم ـ لغير سبب واضح ـ أقل من غيره إجادة للحرف المختلفة.
والحق أن ما نراه الآن هو أثر التدين المغشوش الذى سيطر على المسلمين حينا من الدهر، وجعل فهمهم قاصرا للدين والدنيا معا.
(د) أرى تنظيم فرق للفتوة، أو بتعبير العصر فرق للكشافة والجوالة، إن الرياضة البدنية تصنع الأجسام والنفوس صناعة حسنة، وتنشئ مشاركات اجتماعية طيبة.
والاهتمام بالرياضة لا يكون بإقامة بعض الأندية المتخصصة فى لعبة كذا أو كذا.. ربما أفاد ذلك بعض المنتمين لهذه الأندية، على حين تتحول الجماهير إلى طوائف من المشجعين العاطلين..!!.
وقد راقبت الفرق العربية التى تذهب للمباريات العالمية فوجدت أغلبها يعود فاشلا صفر اليدين من أقل الجوائز.. أما الدول العظمى فتظفر بأغلى الجوائز، وتكسر أرقاما قياسية كما يقولون، فأدركت أننا متعبون جسمانيا وروحانيا على سواء!.
وعلاج ذلك العجز يبدأ من تصحيح القاعدة الشعبية نفسها.
فقد تقول: ثم ماذا؟ بعد أن تنشأ للإسلام أمة قوية الروح والجسد قوية العقل والعاطفة.
أجيب: لن تكون لهذه الأمة مطامع جنسية أو مادية، ولن تزعم أن الدم الآرى أفضل من الدم السامى، أو أن أولاد يعقوب أشرف من أولاد اسماعيل.
إن رسالتها أن تكون مع المظلوم حتى ينتصف، ومع المحروم حتى يستغنى، ولن تكون لها قداسة إذا أهانت الحق، أو استوحش الحق فى جنباتها.
رسالة الأمة ـ كما شرحها كتابها ـ فعل الخير والدعوة إليه، عمل المعروف ومحو المنكر!.
ومعني الخير مركوز فى فطرة البشر وقد يضبطه الوحى الإلهى ويزيل ما يشوبه من لبس، وكذلك معنى المعروف، فإن العقل والنقل يتطابقان غالبا على إبرازه ودعمه..
وإيراد رسالة الأمة تحت هذا العنوان مقصود حتى يعرف القاصى والدانى ما هى وجهتها وما هى شرعتها؟.
وعندما نقوم وفق معالم أسلافنا فستكون تلك صبغتنا فى المجتمع الدولى، وقد نسفك دماء أبنائنا لنحرر الزنوج فى جنوب إفريقية لا لشىء إلا لإرضاء الله وإقرار الحق!!.
إن أسلافنا الأوائل عندما قاتلوا قديما كانت تتملكهم هذه النزعة النبيلة، ومن زعم أن الاستعمار الرومانى أو الفارسى كان جديرا بالمهادنة فهو مفتر جرىء.
وما أنكر أن المسلمين فى أعصار شتى ملك أمرهم من ظلمهم وظلم الناس معهم، وسوأ سمعتهم وسمعة الدين الذى نبت بين ظهرانيهم!.
على أننا لم نفلت وما يفلت غيرنا من عقاب الله، ونحن نقرأ فى كتابنا أن المستقبل لا تصنعه الأمانى الخادعة، وأن مزاعمنا ومزاعم غيرنا لا وزن لها عند الله الذى يقول : (ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا).
إن ديننا يزن الأعمال بمثقال الذرة لا يقبل الفوضى الهائلة التى تقع بين الناس، سواء كانوا مسلمين، أم كانوا يهودا أو نصارى..
----------( يُتَّبع )----------
#محمد_الغزالى
#الطريق_من_هنا
نشر في 11 تموز 2018

تابع
متابع
تابع
متابع
تابع
متابع
تابع
متابع
تابع
متابع
تابع
متابع
تابع
متابع
تابع
متابع
تابع
متابع

 أديان
أديان علوم
علوم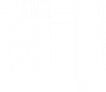 منوع
منوع ثقافة
ثقافة أدبيات
أدبيات تاريخ وجغرافيا
تاريخ وجغرافيا تقني
تقني










