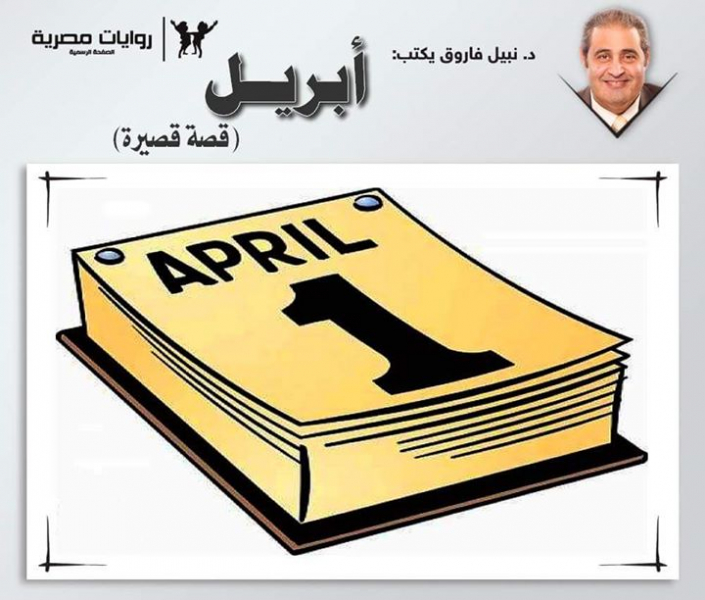
1165 مشاهدة
0
0
طرحت السؤال على نفسي، وأنا أنطلق بسيارتي الصغيرة، متجها إلى تلك القرية الساحلية، التي لست أدري لماذا اختارها فوزي مكانا للقاء في منتصف الشتاء ولا أدري حتى لماذا هذا الأسلوب الذي لم يتبعه من قبل قط
"لماذا طلب فوزي مقابلتي اليوم؟!".طرحت السؤال على نفسي، وأنا أنطلق بسيارتي الصغيرة، متجها إلى تلك القرية الساحلية، التي لست أدري لماذا اختارها فوزي مكانا للقاء في منتصف الشتاء.
ولا أدري حتى لماذا هذا الأسلوب الذي لم يتبعه من قبل قط.
لقد طلب اللقاء عبر رسالة نصية استقبلها هاتفي المحمول في منتصف ليلة أمس، وهو يؤكد فيها أهمية اللقاء، وفي هذا المكان بالذات!
ولقد حاولت عبثا الاتصال به مرات ومرات، لأكثر من ساعة كاملة، لأخبره بأن الوقت متأخر للغاية، وهو يصر على أن يتم اللقاء فجر اليوم، لأهميته وخطورته..
لم أكن أسمع حتى رنينا، كلما حاولت الاتصال به..
فقط صمت..
مجرد صمت تام..
ولأنني لست من روّاد تلك القرى السياحية الساحلية، فقد افترضت أن موقعها غير مغطى بشبكات اتصال، على الرغم من أنه حتى هذا لا يفسر الصمت الذي يستقبل كل محاولاتي للاتصال..
ففي كل الأحيان، إما أن تتلقى رسالة آلية تخبرك أن الهاتف غير متاح، وإما أن الهاتف مغلق..
ولكن كل ما أتلقاه هو صمت عجيب بلا أي تفسير..
ولما كانت الرسالة تحمل دلالات خطورة وأهمية اللقاء، ولأن فوزي هو ناشر سلسلة الرعب التي أقوم بكتابتها منذ سنوات، فقمت أرتدي ملابسي بعد ساعة ونصف من بداية اليوم الجديد، واستقليت سيارتي الصغيرة وانطلقت بها، على الرغم من كراهيتي الشديدة للقيادة الليلية..
وطوال الطريق رحت أدندن بكل ما أعرفه من أغنيات، في محاولة لمنع عقلي من الاستسلام لتلك الرغبة الملحّة في النوم وأنا أقطع الطريق الصحراوي، ثم أدور عند منحنى معروف، لأنطلق في طريق العلمين الجديد، والذي يدّخر مساحة كبيرة وزمنا أكبر من الرحلة الشاقة..
ولكن حتى تلك الدندنة لم تفلح في إقناع عقلي بالاستيقاظ التام، فأدرت مذياع السيارة ورفعت صوته إلى درجة مرتفعة، لعل هذا يقاوم استسلام عقلي..
وطريق العلمين طويل ومظلم وممل، ويساعد أي عقل على التراخي والاستسلام، مما جعلني أهتف في غيظ:
- أكان من الضروري أن تنقل لي جنونك هذا يا فوزي؟!
أغمضت عيني في قوة، دون أن أخفض من سرعتي، ثم عدت أفتحهما، و..
فوجئت بقافلة من الجِمال تعبر الطريق على مسافة أمتار قليلة، دون أن تبالي بأضواء السيارة التي غمرتها، وجعلتها تبدو وسط الظلام كجبال صغيرة متحركة..
وبكل قوتي ضغطت فرامل السيارة وانحرفت بها، محاولا تفادي الاصطدام، فمالت السيارة في عنف خارج الطريق وسقطت وسط الرمال التي تحيط به من الجانبين، وشعرت بجسدي يرتطم بكل جزء منها، على الرغم من حرصي على ارتداء حزام المقعد من قبل حتى أن يصدر قانون يحتم هذا..
ويبدو أنني قد فقدت الوعي للحظة أو لحظتين، إذ انتبهت فجأة لأنني داخل السيارة المقلوبة فوق الرمال، فرحت أعمل جاهدا على حل حزام المقعد، ثم زحفت خارج السيارة ووقفت أتطلع إليها في يأس وألم..
"اللعنة يا فوزي.. ماذا سأفعل الآن؟!".
هتفت بالعبارة والسؤال في أعماقي، وزفرت في حنق، وألقيت نظرة على ساعة يدي، التي توقفت عقاربها عند الثالثة وتسع دقائق بالضبط..
ولم يكن هناك أثر لقافلة الجمال..
ولا لأي سيارات أخرى على الطريق..
وكان هذا يعني أنني سأظل هنا وحيدا، أو أقطع ما تبقى من الطريق سيرا على الأقدام!
بحثت في جيب سترتي عن هاتفي المحمول، ولكنه لم يكن يتلقى إشارات من أي نوع، فعدت أدسّه في جيبي وأتلفّت حولي..
ثم لمحت ذلك الضوء..
رباه! هناك مكان على بعد ثلاثمائة متر فحسب، تنبعث منه الأضواء..
كيف لم أنتبه إليه من قبل؟!
كيف؟!
أسرعت الخطى نحو ذلك المكان، الذي صار يمثل بالنسبة إليّ كل الأمل في الخروج من هذا الموقف العسير..
وعلى الرغم من أنه كان يبدو على بعد ثلاثمائة متر، لكنني وصلت إليه في سرعة أدهشتني شخصيا، ولمحت اللافتة المضيئة فوقه..
"المحطة"
اسم عجيب لمكان في هذا الموقع!
لعلها استراحة اختار لها أصحابها هذا المكان لينفرد بخدمة رواد الطريق، الذي لم تمتد إليه يد العمران بعد..
ومن حسن الحظ أنه لم يغلقه في فصل الشتاء..
التقطت نفسا عميقا، ودفعت باب المكان، ودلفت إلى الداخل..
وكم أدهشني أن المكان لم يكن خاليا كما توقعت..
لقد كان مزدحما بالروّاد، على الرغم من أنني لم ألمح أي سيارات خارجه..
وكان هناك رجل طويل القامة، صارم الملامح، يقف خلف ما بدا شبه بار من الخشب، ويتبادل الأحاديث مع بعض الرواد، مما أوحى إليّ بأنه المسئول عن المكان، فاتجهت إليه مباشرة أسأله: معذرة.. أيوجد هاتف هنا يمكنني استخدامه لطلب إسعاف الطريق؟
ألقى الرجل عليّ نظرة لا مبالية، قبل أن يسألني في هدوء:
- حادث سيارة آخر؟!
أومأت برأسي إيجابا:
- لقد فاجأني قطيع من الجمال يعبر الطريق.
مط شفتيه الغليظتين، وهو يغمغم:
- هذا يحدث باستمرار.
ثم أشار إلى مائدة خالية، مستطردا:
- انتظر هنا، حتى يحين دورك.
قلت في عصبية لم أتعمدها:
- أي دور؟! أسألك عن هاتف!
شد قامته، فبدا أكثر طولا وصرامة، وهو يقول:
- لا يوجد هاتف.. الهواتف لا تعمل هنا.. انتظر وسيحين دورك.
في مثل موقفي، لم يكن أمامي سوى أن أفعل ما يطلبه، فاتجهت إلى المائدة الخالية، وجلست أنتظر دون أن أدري حتى ما الذي أنتظره..
لم أدرِ حتى كم من الوقت قبل أن أشعر بيد توضع على كتفي من الخلف، وأسمع صوتا مألوفا يقول:
- إذن فقد وصلت.
التفت إلى صاحب الصوت، هاتفا:
- فوزي؟! كيف علمت أنني هنا؟!
ابتسم دون أن يجيب، وجذب مقعدا ليجلس إلى جواري، وهو يسأل:
- ما رأيك بالمكان؟!
سألته في حذر:
- أأنت مالكه؟!
ضحك، قائلا:
- بل أزوره للمرة الأولى.
عدت أسأله في إلحاح:
- ولكن كيف علمت أنني هنا؟!
مرة أخرى تجاهل إجابة السؤال، وهو يقول في حماس:
- هل تعلم؟ على الرغم من أنني ناشر كتبك، ومن كل ما تحققه من نجاح وانتشار، لكنني لم أكن أصدّق حرفا واحدا، مما تكتبه فيها.
قلت في ضيق:
- ولكنك ربحت منها عشرات الألوف.
ضحك مرة أخرى، ولوّح بيده قائلا:
- بل مئات الألوف في الواقع.
قلت في غيظ:
- لو أنك تربح مئات الألوف مما أكتبه، فلماذا رفضت إقراضي مقدم سيارة كبيرة؟!
بدا عليه الأسف لحظة، ثم عاد يبتسم وهو يميل نحوي قائلا:
- أنت تعرف قاعدة الناشرين الذهبية.
نظرت إليه في تساؤل محنق، فتراجع في مقعده مضيفا وابتسامته تتسع:
- لماذا تدفع أكثر، ما دام بمقدروك أن تدفع أقل؟!
شعرت بالغيظ، ليس لإجابته وحدها، ولكن للأسلوب المستهتر الذي نطقها به، فقلت في شيء من الحدة:
- لماذا إذن كان هذا الموعد العجيب الذي خسرت فيه سيارتي الصغيرة، وكدت أخسر فيه حياتي أيضا؟!
رمقني بنظرة طويلة قبل أن يجيب:
- هل تعرف تاريخ اليوم؟!
أجبته في حدة:
- بالطبع.. إنه الأول من إبريل، عام...
بترت عبارتي دفعة واحدة، وأنا أحدّق فيه، ذاهلا وغاضبا في الوقت ذاته!
الأول من إبريل؟!
أمن الممكن أن يكون الاستهتار قد بلغ به هذا الحد؟!
أكل هذا مجرد خدعة الأول من إبريل؟!
أقسم أن أقتله لو أن الأمر كذلك..
لا.. لن أقتله فحسب، بل سأمزقه إربا..
"هي كذبة إبريل إذن؟!".
هتفت بالعبارة بكل ما اعتمل في نفسي من غضب، وتوقعت منه ضحكة عالية، تحمل الكثير من المرح والاستهتار..
والاستفزاز أيضا..
ولكن العجيب أنه حدق في وجهي بدهشة، وهو يغمغم:
- كذبة إبريل؟! أي سخافة هذه؟!
قلت في حدة:
- لا تحاول مواصلة اللعبة معي.. منذ البداية، لم أشعر بالارتياح، عندما تلقيت رسالتك.. ووجودك هنا يؤكد أنك قد دبّرت كل شيء.
ظل صامتا لحظة، ثم مال نحوي يسألني:
- وما الذي دبرته بالضبط؟!
أجبت بنفس الحدة:
- اضطراري إلى السفر ليلا، وقطيع الجمال، وهذا المكان، و..
توقفت عن الاستطراد دفعة واحدة، وبدت الحيرة على وجهي، مما جعله يميل أكثر، متسائلا بابتسامة هادئة:
- وماذا؟!
لم أستطع إجابته هذه المرة..
فكل ما قلته كان مجرد خيال جامح..
كيف كان سيعلم موعد وصولي ليعد قطيع الجمال؟!
وكيف جعل هاتفه يجيب بهذا الصمت المريب؟!
وكيف؟!
وكيف؟!
كانت الأسئلة تنهال على رأسي، عندما تنهد هو وغمغم:
- من الواضح أنك لم تفهم بعد.
وتنهد مرة أخرى، قبل أن يضيف:
- إنه قدرنا يا صديقي.. أن يفصلنا يوم واحد.
سألته في صعوبة، وكل قصص الرعب التي كتبتها، تنهمر على رأسي كالمطر:
- ماذا تعني؟!
أجاب في هدوء:
- لقد لقيت أنا مصرعي أمس.. اقتحم كاتب مجنون مكتبي في التاسعة مساء، عندما كنت أهم بالانصراف، وأطلق النار على رأسي مباشرة.
لست أدري كيف انتبهت فجأة لتلك البقعة الحمراء فوق حاجبيه، والتي تجمع حولها دم متجلط، وشعرت برعب شديد وهو يشير إليها مستطردا:
- وكل هذا بسبب خلاف على ألف جنيه؟! هل يمكنك أن تتخيل؟! ألف جنيه فحسب، دفعته إلى قتلي!
شحب وجهي، لو أن هذا المصطلح يصلح في حالتي، وغمضت في انهيار:
- أيعني هذا أنني...
قاطعني في هدوء:
- لقيت مصرعك في حادث السيارة.. نعم.. قلمك قتلك يا صديقي.. كنت تضعه في جيب سترتك، فانغرس في قلبك مع الصدمة.
مع قوله لاحظت ذلك القلم الذي كتبت به معظم رواياتي الناجحة، وقد برزت مؤخرته من موضع قلبي مباشرة، محاطة بالكثير من الدماء، في نفس اللحظة التي ظهر فيها ذلك الطويل الصارم إلى جوارنا، وهو يقول في غلظة:
- هيا.. لقد حان دوركما.
نهضت مع فوزي في استسلام، متجهين نحو ذلك الباب، الذي يشع منه ضوء مبهر، والذي يعبره بعض رواد المكان، وفوزي يسألني في هدوء:
- ما رأيك؟! أيهما أكثر رعبا.. رواياتك، أم الحقيقة؟!
لم أجب سؤاله، وأنا أغمغم في أعماقي..
ليتها كانت كذبة إبريل!
ليتها كانت كذلك!
نشر في 01 نيسان 2018


 أديان
أديان علوم
علوم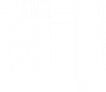 منوع
منوع ثقافة
ثقافة أدبيات
أدبيات تاريخ وجغرافيا
تاريخ وجغرافيا تقني
تقني









