
2283 مشاهدة
3
0
كانت الملائكة متشائمة من مستقبل الإنسان على ظهر الأرض، وإن هذا العلم ينظم الإنسان مع الملائكة فى الشهادة لله الكبير بالتوحيد والعدل
كتاب : علل وأدوية - بقلم : الشيخ محمد الغزاليالحلقة [ 2 ] الإنسان فى القرآن
كانت الملائكة متشائمة من مستقبل الإنسان على ظهر الأرض.. لعلها أحست أن أصله الترابى سيجعله هشا أمام الاختبارات الصلبة، وأنه سيفقد تماسكه أمام الأهواء والمغريات؟
لعلها رأت أنه يشبه أجناسا أخرى لم تصدع بأمر الله، ولم تحسن تنفيذ وصاياه..؟ أو لعل شعاعا من عالم الغيب طلع عليها فرأت معه صورا من الحروب الدامية، والمسالك المعوجة التى سوف يخوضها البشر، ويظلمون بها أنفسهم.
على أى حال لقد تساءلت الملائكة وقالت لله جل شأنه: (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) وكان الجواب الأعلى: (إني أعلم ما لا تعلمون).
وخلق الله آدم ووهب له عقلا محيطا بالأشياء كلها، ووضع فى هذا العقل خاصة باهرة يستمكن بها من معرفة الأسرار والظواهر، ويهيمن بها على شتيت من القوى والعناصر، إن هذا المحدود فى أعضائه ومشاعره يملك طاقات ضخمة تجعله سيدا لما حوله، بل تجعله ملكا واسع السلطان ممدود النفوذ. ولعل الملائكة اليوم ترقبه دهشة وهو يخترق الفضاء ويغزو الكواكب.
لكن عظمة الإنسان لا تكمن فى هذه القدرات الطليعة، إنها تكمن فى أمر آخر أهم منها وأجل، هو معرفته لمن خلقه فسواه، لمن أعلى قدره ورفع مستواه! لله الذى خلق هذا الكون ومكنه فيه وسخره له.
إن هذا الفريق من الناس الذى عرف ربه وأسلم له وجهه، وافتتح مغاليق الحياة باسمه، هو الذى يبرز الحكمة من وجود الإنسان فى العالم، وأحسب أن هذا الفريق الصالح المصلح هو الذى استشفت الملائكة خبره ثم قالت لله : (قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم).
وقصة الحياة الإنسانية كما ساقها القرآن الكريم تستوقف النظر من نواح عدة نحب أن نتبينها :
أولها هذا التنعيم الذى أحاط بها منذ بدايتها، فبين يدى عرض القصة فى سورة البقرة نقرأ قوله تعالى : (هو الذي خلق لكم ما في الأرض). وقبل ذلك بقليل نقرأ: (الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم).
وبين يدى عرضها فى سورة الأعراف نقرأ قوله: (ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون * ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم).
وبين يدى عرضها فى سورة الحجر، سرد للنعم التى تحف الحياة البشرية نقرأ منه قوله تعالى: (ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين * وحفظناها من كل شيطان رجيم * إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين * والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون * وجعلنا لكم فيها معايش).
والواقع أن الرغيف الذى يطعمه إنسان تشترك فى إنباته وإنضاجه فجاج الأرض وآفاق السماء. فتربة الأرض، والسحب الهامية، والأشعة العمودية أو المائلة التى تتعرض لها الحقول وأثر الضوء فى تكوين الخضرة مثلا وأشياء أخرى كثيرة تتعاون جميعا على تكوين الغذاء والكساء. والدواء الذى يحتاج إليه البشر.
إن شبكة من المواد الدقيقة جدا، والجسيمة جدا، انتظصت فى خدمة الإنسان وتأمين معايشه وتخطيط حاضره ومستقبله، كل يؤدى دوره بوفاء وقدرة، الكواكب السابحة فى الفضاء، والجراثيم التى لا تراها العين!
وذاك سر الأقسام الكثيرة التى وردت فى القرآن الكريم مشيرة إلى فخامة هذا العالم. (فلا أقسم بالشفق * والليل وما وسق * والقمر إذا اتسق * لتركبن طبقا عن طبق). (كلا والقمر * والليل إذ أدبر * والصبح إذا أسفر * إنها لإحدى الكبر).
وتدبر القسم بالرياح المثيرة والسحب الحافلة وما يتبع ذلك من زرع وحصاد وتجارة واحتراف وخيرات تعم البشر: (والذاريات ذروا * فالحاملات وقرا * فالجاريات يسرا * فالمقسمات أمرا * إنما توعدون لصادق).
إن رب العالمين أبدع ما صنع! وحدثنا عن هذا الإبداع لنعجب به ونتذوق جماله.
وإنى لأستغرب أحوال الناس ينتسبون إلى الإسلام ويديرون ظهرهم للكون، فلا يدرسون له قانونا، ولا يكشفون له سرا.
أى إيمان هذا؟ وأى جهل بقصة الحياة ووظيفة آدم وبنيه فى ربوعها..؟
إن الإنسان فى القرآن الكريم كائن مكرم مفضل محترم مخدوم، ومن حق الله تبارك اسمه أن يعاتب البشر على سوء تقديرهم لآلائه: (ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير).
هذه ناحية تتصل بالتكريم المادى للإنسان، وثم ناحية ثانية تتصل بكيانه المعنوى. فالإنسان نفخة من روح الله الأعلى، هكذا بدأ خلق آدم، وهكذا تتخلق الأجنة فى بطون الأمهات.
إن الحياة فى شتى الأجسام المتحركة شىء، وخصائص الحياة الرفيعة فى أبناء آدم شىء آخر، وقد أشاع الله نعمة الخلق بين خلائق كثيرة برزت من العدم إلى الوجود، بيد أن آدم وحده هو الذى وصفه بقوله: (سويته ونفخت فيه من روحي).
واطرد هذا التكريم فى ذريته إلى قيام الساعة: (الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين * ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين * ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة).
والإنسان بهذه النفخة كائن جديد يعلو فوق ما يشبهه من ضروب الحيوان ولذلك قال جل شأنه: (فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين).
وبعد أن تم خلق آدم على هذه الصورة أمر اله الملائكة أن تسجد له سجود تعظيم وتوقير لا سجود عبادة!
والملائكة هى التى أبدت دهشتها لإيجاد هذا الإنسان واستنكرت ما سوف يقع منه من فساد وفوضى. إنها طولبت بالسجود له بعدما تم تكوينه! وعوقب من رفض السجود بالطرد من رحمة الله.
وسواء أكان إبليس من الملائكة، أم كان وجوده بينهم وهو من الجن، فإن النتيجة لا تختلف، إذ إن الاستهانة بالإنسان هى عند الله عصيان وخيم العاقبة!
وهذا التكريم البين ينضم إليه أمر آخر عظيم الدلالة على مكانة الإنسان وحفاوة الله به ، هذا الأمر هو الفرح الإلهى بعودة الإنسان التائب واستقبال الله له بإعزاز بالغ وتجاوزه عما فرط منه من خطأ وقوله فى عفو شامل: (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى).
كلتا الناحيتين من تكريم وتنعيم استتبعت ناحية ثالثة كان لها الأثر الأكبر فى مستقبل الإنسان ومستقبل الكوكب الذى أعد لسكناه، بل فى مستقبل المجموعة الشمسية كلها التى سينتثر عقدها وينطفئ نورها مع انتهاء الرسالة الإنسانية على ظهر الأرض!.
هذه الناحية هى (التكليف) ؛ فإن الله الذى زود الإنسان بهذا السمو فى مواهبه لم يتركه سدى، بل أمره ونهاه وطلب منه أن يفعل وأن يترك! وربما كلفه أن يفعل ما يثقله، وأن يترك ما يشتهيه. وهنا نقف وقفة أمام سر التكليف ومعناه لنتناول جملة أمور.
إن أبانا آدم، وهو الإنسان الأول، كلف ألا يأكل من شجرة معينة وكان جديرا به أن يعرف حق الآمر جل شأنه وأن يدع الأكل من هذه الشجرة أبدا.
ولكنه بعد مرحلة من الذهول والضعف، عرضت له ساعة انهيار فى إرادته وامتداد فى رغبته فأكل من الشجرة المحرمة، وشاركته زوجته فى عصيانه فطردا جميعا من الجنة. وكانا قد أحسا بالخطأ الذى تورطا فيه فدعوا الله نادمين:
(قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين * قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين * قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون).
ونزل أبونا إلى الأرض وشرع كثير من الأبناء يمثلون القصة نفسها ويرتكبون الخطأ ذاته، ولكنه ليس أكلا من شجرة بل اتباعا للشهوات التى تقود إلى العصيان والحرمان!
العنوان متغير والحقيقة واحدة.. إن هذا السلوك من الإنسان الأول يجعلنا نتساءل عن علته ؟ والعلة واضحة فإن الإنسان بدأ حياته بطبيعة مزدوجة، قبس من نور الله داخل غلاف من طين الأرض!
إن الله تبارك اسمه بعدما صور الإنسان من التراب وسواه، نفخ فيه من روحه، فإذا كائن عجيب يجمع النقائض فى تركيبه، يقدر على التسامى وعلى الإسفاف، ويقدر على الاستقامة وعلى الانحراف.
وقد نبه القرآن الكريم إلى هذا الخليط فى التكوين البشرى فقال جل شأنه: (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا).
كما نبه إلى أن إلمامه بالخطايا ليس مستغربا، إنه ينزع إلى عرق فيه: (الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم).
كلتا النزعتين الأرضية والسماوية تجد فى الحياة ـ أو فى البيئة ـ ما يضعفها أو يقويها، وقبل ذلك كله تجد فى الإنسان نفسه ما يرجح كفة على أخرى، وما يسلم زمامه للخير أو للشر، كما يريد هو لنفسه دون تدخل من أحد فى اتجاهه هنا أو هنا.
إن إيثار الوقوف عند الإشارة الحمراء أو المروق منها والتعرض لأخطار الانطلاق الأحمق تصرف إنسانى محض.
وفى هذا يقول تعالى: (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين * ولو شئنا لرفعناه بها). أى لو تسامى وترفع. (ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه) فتركه الله حيث شاء لنفسه.
ولابد من توكيد هده الحقيقة، حقيقة الإرادة الحرة فى الصعود والهبوط، وفى التقوى والفجور، وفى إغضاب الله أو إرضائه، فإن الرحمن الرحيم يستحيل أن ينقم على إنسان سعى فى مرضاته، كما أنه لا يرضى عن إنسان سعى فى إغضابه.
وبعض الناس يمارى فى هذه الحقيقة من مكابرة، أو تحمل أعذار وهيهات.. فقصة الوجود الإنسانى تقوم على اختبار حقيقى لاكتشاف المحسن والمسيء. (الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا).
والمحسن إنسان أتقن العمل واحترم الصواب. والمسيء إنسان فرط ولزم العوج. والعراك داخل النفس الإنسانية لاختيار أحد النهجين عراك حقيقى لا صورى.
وتلمح صدق هذا العراك وقبول نتائجه فى قوله تعالى: (فأما من طغى * وآثر الحياة الدنيا * فإن الجحيم هي المأوى * وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى * فإن الجنة هي المأوى).
إن السالم فى هذا العراك إنسان يشعر بقيام الله عليه وعلى سائر الكائنات، ومع نماء هذا الشعور يخفت صوت الهوى ويغلبه صوت الضمير اليقظان أو القلب الحى.. فأين التمثيل أو المحاباة أو الخداع فى هذه الحالات؟
الله جل شأنه ينادى الإنسان ويذكره ويهديه، وعلى الإنسان أن يلبى ويتذكر ويهتدى، فإذا أبى إلا الشرود فهو وحده الملوم، ومن ثم تقررت هذه الأحكام العادلة التى ندركها من قوله تعالى:
(قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها). (ونفس وما سواها * فألهمها فجورها وتقواها * قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها).
والتزكية والتدسية جهد بشرى محض، أو كذلك يكون أول الطريق ثم يلحقه من مشيئة الله ما يصل به إلى النهاية: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم).
ونتساءل مرة ثانية: ما قيمة الصوت المضلل الذى يستمع إليه الإنسان فيزيغ ويشقى؟
الحق أن صداه الضخم أضعاف أضعاف حقيقته التافهة، إنه كنقيق الضفدعة يملأ أكناف الليل ومصدره لا قيمة له!
ما الشجرة التى أكل منها آدم؟ هل أحس طويلا لذة ثمرها ومتعة ازدرادها؟ لقد كانت وهما هذه النشوة المأمولة ولو فرضناها لذة ساعة فما قيمتها! إذا وزنت بما أعقبتها من حسرات سنين عددا؟ بل دهرا طويلا!
إن الإنسان فى هذه الدنيا تهيجه رغبة حمقاء إلى شىء محرم ما أن يواقعه حتى يحس الفراغ والضياع، وحقيق بالإنسان أن يتماسك أمام عوامل الاستفزاز ومزالق القدم.
ونتساءل مرة أخرى: ما مصدر هذا الصوت النابى الجهول الذى يذل الإنسان؟
والجواب أن له مصدرين اثنين: أولهما نفس الإنسان أو الإهاب الترابى الذى غلفت به، والمصدر الثانى من كائن آخر خاصم الإنسان من النشأة الأولى وهو الشيطان الذى آلى على نفسه استدامة هذا الخصام إلى يوم النشور.
فى المصدر الداخلى للمعصية يقول الله تعالى: (ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما).
فالنسيان وضعف العزيمة رذيلتان وقع فيهما الإنسان الأول، ومع تولدهما فى نفسه تتهيأ الإمكانات للشيطان كى يوسوس ويخادع ويقول لآدم وامرأته: (ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين * وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين * فدلاهما بغرور).
وما تمت هذه التدلة ولا نجح الشيطان فى خدعته إلا لأن آدم كان قد ضعفت ذاكرته وضعفت إرادته.
والضعف النفسى أولا، ثم وساوس الشيطان ثانيا.. ولا عبرة بما يتعلل به المخطئون من أن الشيطان هو السبب الأول والأخير فى انحدارهم!
إن الشيطان محطة إرسال يذيع منها فنون الإغراء والإغواء، والإنسان هو الذى يهيئ أقطار نفسه لاستقبال هذه الإذاعات والتجاوب معها.
وأنت الذى تتخير ما تسمع من محطات (الراديو) المختلفة، ولو شئت أغلقت للفور ما تعاف سماعه، وابتعدت عنه حتى لا يصل صداه إلى سمعك، أو قاومته بمشاعر النفور والمقت حتى لا يستولى عليك!
وقد منح الشيطان من أول يوم القدرة على إغراء الإنسان وخداعه. ودفعته خصومته إلى ابتكار وسائل كثيرة ونصب أحابيل مختلفة لإيقاع الأغرار والغافلين، وقيل له: (واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك).
وكان الشيطان لا يملك أكثر من الكلام يكذب فيه ويغر، وقد نبه الله آدم وبنيه من هذا العدو الغار الكاذب. وحذرهم من الشراك المنصوبة والأقاويل المزورة.
إن الشيطان يعد كذبا، ويقسم حانثا، وينصح غاشا، ويلين ليلدغ وينحنى ليثب ويصرع. وهو فى هذا كله لا يملك إلا شيئا واحدا، الكلام، الكلام وحده! فلا يجوز أن نصدقه: ( يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى). (أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا).
ومع ذلك فقد قدر الشيطان بالكلام المضلل أن يزيغ الكثيرين. وسيقول يوم القيامة لمن استجابوا له: (وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم).
إن سلاح الشيطان مفلول والنجاة منه ميسورة! وعندما يقع البعض فى قبضته فلا حماية له لأن القانون لا يحمى المغفلين.
ومن ثم فالجهد الحقيقى فى النصح والتربية يتجه إلى الإنسان أولا وآخرا ليوقظ فيه أسباب الحذر، وليسد الثغرات التى يمكن أن يتسلل منها الشيطان بوساوسه الماكرة.
لقد أشرنا إلى الأمشاج التى يتكون منها الإنسان، والحق أن فى الإنسان ـ مع أصله السماوى ـ طباعا لا يجوز تركها حرة تتصرف كما تشاء، لابد من مراقبتها وإخضاع حركتها وسكناتها لحكم الله، وإلا جرته من القمة إلى الحضيض : (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم * ثم رددناه أسفل سافلين).
وليس معنى هذا الرد أنه تحول إلى مسخ ذميم بعدما كان فى ذروة الحسن!
كلا. المعنى أن إمكانات الهبوط جاورت معانى الرفعة فى نفسه، وأنه يستطيع التحليق والإسفاف معا، وذاك سر الاستثناء بعد: (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات).
أى سوف يبقى قوامهم حسنا، ماديا ومعنويا! وجاءت فى القرآن الكريم آيات كثيرة تقرر الطباع الرديئة التى ينبغى الخلاص منها.
فالإنسان (أنانى) يحب نفسه وحسب، وقد تكون محبة النفس أصلا فى استبقاء الحياة، ولكن هذه المحبة تتحول إلى مرض خطير يورث الشره والطمع والبغى واجتياح الحقوق بنزق.
وقد ذكر القرآن أن هذه الأثرة لا يطفئها الغنى مهما اتسع: (قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا).
والإنسان نساء أو غافل، وقد يكون هذا أو ذاك أصلا فى استبقاء الحياة، فلو استصحب المرء حزنه إلى الأبد على ما فقد ما صلحت الدنيا.
ولكن هذا الذهول قد يكون جرثومة الكنود ونكران الجميل ونسيان الرب وما أولى: (وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا).
(إن الإنسان لربه لكنود * وإنه على ذلك لشهيد).
والإنسان الذى يحلو له أحيانا أن يفخر، ويتطاول، وينظر إلى السماء بقلة اكتراث، تذله علة فى أى مكان فى جسمه أو تذله غلطة فى أى وقت من تفكيره مهما كان عبقريا. (يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا).
والإنسان محتال كبير فى الدفاع عن نفسه، والتماس الأعذار لأخطائه وعد ما يقع منه وجهة نظر مقبولة أو مغفورة. (وكان الإنسان أكثر شيء جدلا).
وهذه الطبائع جميعا مزالق لمن يسترسل معها، وقد نبه القرآن الكريم إلى أمراض شتى تعترى النفس، فالإنسان قد يبطر على الغنى، ويطغى مع السلطة، ويقنط مع الفشل، وقد يستحلى من شهوات النساء والرياء والاستعلاء ما يحيله إلى عبد لنفسه وهواه.
ولكن الفكاك من هذه الآثام كلها ميسور، فإن القرآن الكريم لما خوف عواقب هذه الانحرافات الإنسانية ذكر أسباب النجاة منها: (والعصر * إن الإنسان لفي خسر * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبرِ).
وما أجملته سورة العصر من وصف للداء والدواء فصلته سور أخرى. نختار منها سورة المعارج التى أسندت للإنسان هذه الخلال: (إن الإنسان خلق هلوعا * إذا مسه الشر جزوعا * وإذا مسه الخير منوعا).
لكن الإنسان يبرأ من هذه العلل إذا قام بجملة العبادات المفروضة. ونتساءل: هل هذه العبادات (مصل) واق أم شفاء من أمراض توجد وتتجدد؟ قد يكون هذا أو ذاك.
ولنتدبر أولا الاستثناء الذى تضمنته السورة الكريمة: (إلا المصلين * الذين هم على صلاتهم دائمون * والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم * والذين يصدقون بيوم الدين * والذين هم من عذاب ربهم مشفقون * إن عذاب ربهم غير مأمون * والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون * والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون * والذين هم بشهاداتهم قائمون * والذين هم على صلاتهم يحافظون * أولئك في جنات مكرمون).
لا شك أن هذه العبادات مجتمعة تنشى إنسانا كاملا شريطة أن تؤدى أداء حقيقيا لا أداء تمثيليا، وأحب أن أقف عند واحدة من هذه العبادات لأتأملها وأتعرف على آثارها النفسية، وهى قوله تعالى: (والذين هم بشهاداتهم قائمون).
إن الإنسان المسلم يجب أن يكون مستعدا دائما لأداء الشهادة على وجهها، وليحق الحق، ويبطل الباطل، ويدعم العدالة. والقيام بالشهادة يتطلب صراحة لا تخاف فى الله لومة لائم، ذلك أن الحق يختنق فى هذه الدنيا وسط دخان الشهوات المتصاعد من هنا ومن هناك.
والمرء ينكل عن الأداء بالرأى الصحيح والقول الصحيح لأنه يخشى على مستقبله مثلا، أو يريد محاباة قريب، أو يطمع فى مال، أو يتطلع إلى منصب، إنه لا يستبين وجه الله من غلظ الحجب على بصيرته!
والمجتمع الإسلامى يسقط مع اختفاء الذين هم بشهاداتهم قائمون. لأن هؤلاء المؤمنين ـ كما يزعمون ـ ليسوا بشهاداتهم قائمين، ربما سكتوا أو قالوا فلم يعدلوا!
وكم رأينا من أناس قدموا وحقهم التأخير أو أخروا وحقهم التقديم.
ولقد عرفت لماذا سبقت بعض المجتمعات سبقا بعيدا عندما قرأت أن زوج الملكة فى هولندا عزل وجرد من أوسمته لما كشفت صلته بقضية رشوة، وأن رئيس وزراء اليابان عزل ورمى به فى السجن للتهمة نفسها.
إن القيام بالشهادة يعنى ألا نترك صاحب حق مستوحشا فى هذه الدنيا لا صديق له ولا ظهير. والشهادة بداهة ليست ما يقال أمام المحاكم فقط، بل ما يقال فى كل خلاف أو مشورة أو اختيار أو انتخاب أو أى شأن ذى بال.
والقائم بالشهادة رجل أسلم لله وجهه وقرر أن يحيا للحق وحده!
وقد تتشابك فى نفس الإنسان عدة طباع مثل تشهى الحياة، وتعجل النتائج وغلبة الأثرة، فيصدر أحكاما خاطئة على ما يصيبه من خير أو شر، وتستبد به المبالغة فتجمح به مشاعره نحو نفسه ونحو الناس.
وفى هذا يقول جل شأنه : (ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور * ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور * إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير).
فى هذه الآيات صورة الإنسان الذى تستعبده الساعة الحاضرة وحدها، فهو عند فقد ما يسر منهزم كسير من شدة القنوط، وعند وجدانه، ينتشى ويغتر من شدة الفرح.
وكان يجب أن يتمالك نفسه فى الحالين وينظر إلي أصابع القدر وراء ما يحسه فيستكين لله ويؤدى ما عليه بتعقل..
ثم ينضم إلى هذا الإحساس المعتدل شعور آخر، أساسه أن ما يناله من خير ليس تمتيعا له وحده، فإن للمحرومين سهما فيما جاءه، وقد يكون سهما كبيرا:
(فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن * وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن * كلا بل لا تكرمون اليتيم * ولا تحاضون على طعام المسكين * وتأكلون التراث أكلا لما * وتحبون المال حبا جما).
والآيات تشير إلى أن الغنى ابتلاء، وأن الفقر ابتلاء، ومن الخطأ تصور أن الإغناء تكريم، والإفقار إهانة، والعبرة بالنتائج، فإن الذى يستعف فى فقره أسبق عند الله وأرجح فى الميزان من الذى يطغى بغناه.
والذى يمنح الثراء، فيفتح أبوابه لليتيم والمسكين ويسارع بالبذل فى مواطن النفقة هو الإنسان الناجح فى الامتحان السابق فى الميدان.
لكن البشر ـ للأسف ـ يحسبون العطاء تدليلا لأشخاصهم، والحرمان إهانة وإذلالا.. وذلك خطأ بالغ فى فهم الدين والدنيا.
وعندما خال الناس أن الغنى تكريم ذاتى لبعض الأفراد والأسر، وأن الفقر هوان ذاتى قصده الله لبعض الأفراد والأسر، عندما شاع ذلك انفجرت براكين الأحقاد ضد أصحاب الثروات، وانفجرت معها عواصف الإلحاد والكفر، وتعرض مستقبل الإنسانية كلها للبوار، وهل انتشرت الشيوعية إلا فى هذا الجو؟
إن العبادة هى السلم الفذ الذى تصعد فيه النفوس الإنسانية إلى الكمال المنشود.
يجب على الإنسان أن يعرف ربه، وأن يقف فى ساحته عبدا نقيا من الآفات والعاهات.
إن آدم لما نسى وضعف أضحى دون مستوى الجنة فأخرج منها. ولن يعود أبناؤه إلى الجنة وهم يحملون أوزار النسيان والضعف، لابد من إيمان واضح وعمل صالح.
وفى طول القرآن وعرضه، توكيد لهذه الحقيقة التى حاول كثيرون الزوغان منها.
ونعود إلى الخاصة الأولى فى تكوين آدم وبنيه، خاصة العقل العالم بالأشياء الخبير بالحقائق والأسماء، إن الإنسان المكلف بعبادة الله لا يعبده بشبحه المحدود، وجسمه المادى القاصر! إنما يعبده بتطويع طاقاته كلها لله.
إنه يضع بصماته المؤمنة على الأرض حتى إذا سجد سجد معه زرعها وضرعها وحديدها وذهبها وكل ما سلك وارتفق!
وأرى أن ذا القرنين عندما ساوى بين الصدفين، وذوب الحديد والنحاس داخل سلسلة من القلاع التى تحمى الضعاف وتذود الطغاة ـ أرى أنه أحق الحق وأبطل الباطل لا بالكلام وحده، ولكن بجعل الأرض ومعالمها ومعادنها تؤدى وظيفته وتحمل طباعه وكأنها امتداد لنبض قلبه وبطش يده.
وهل ملك الله الأرض الإنسان إلا لهذا؟
عندما تعطى خادمك أسباب الزينة والوجاهة فيجيئك أشعث أغبر فأنت تضيق به. والعباد الجهلة بالحياة، والغرباء فى الكون، سوءة زرية، وجهل أو تمرد على الخلافة الإنسانية فى العالم.
ونحن المسلمين سنحاسب حسابا عسيرا على تخلفنا الواضح فى العلوم الطبيعية.
ربما احتاج الإنسان كى يصلى إلى مساحة من الأرض لا تعدو ذراعا فى ذراع، ولكنه كى يدفع العدوان عن هذا المسجد الضئيل يحتاج إلى معرفة تمتد من الأرض إلى المريخ بل إلى الشمس. معرفة فى هذا العصر تهيمن على ما فى الأرض وما فوق البر، وتخترق طباق الجو متحسسة آفاقا بعد آفاق من أغوار الكون البعيد.
كتب الدكتور فاروق الباز الخبير فى غزو الفضاء عن حاجة العرب إلى (متنقل فضائى) يستعينون به على اكتشاف أرضهم وما أودع فيها من خيرات، وأهاب بالحكومات العربية أن تمول هذا المشروع، قال:
( ليس من المستبعد فى نظرى أن تخطو دولة أو دول عربية هذه الخطوة فتحقق ما فيه الخير للعالم العربى كله. نحن نعلم أن الصحراء تكون 96% من جملة الأراضى العربية، ولابد من الانتفاع بجزء كبير من هذه الصحراء إلى جانب دراستها دراسة علمية صحيحة فنحن لا نعلم عن الصحراء إلا قليلا، وربما كان سبب هذا أن علماء الغرب لم يهتموا بالصحراء لقلة الصحارى فى بلادهم ولصعوبة التنقل فى صحرائنا الشاسعة..!
ويلزم العلماء العرب أن يدرسوا الصحراء وتضاريسها وتراكيبها دراسة تفصيلية، لان البادية منبع كل ما هو عربى.
والصحراء تحيط بالعرب من كل ناحية، ويتضح هذا لرواد الفضاء فى المدار الأرضى وضوحا تاما حتى إن رواد القمر كانوا يتعجبون لظهور الصحراء العربية فى صورهم الملتقطة كتلة واحدة على بعد 4.000.000 كيلو متر).
قال: (وتعتبر الصحراء خزانا عظيم الشأن للنفط وللمياه الجوفية ويصلح بعض أجزائها للزراعة المثمرة.
وأهم من ذلك كله أن الصحراء خزان عظيم للطاقة لا نهاية لها هى الطاقة الشمسية، ولذلك يجب أن تشتمل دراسة الصحراء العربية تحديد أصلح الأماكن لأبحاث الطاقة الشمسية وطرق الإفادة منها.
ومن الناحية الاجتماعية يجب أن تشمل الدراسة التعرف على الأماكن المختارة لمعيشة الإنسان وإنشاء المدن الكبيرة والصغيرة وطرق المواصلات ومنتجات السياحة والترفيه، وتحديد بنية الخضرة فى الصحراء لاستغلالها، ومعرفة المؤثرات المختلفة على حياة البدو، إلى غير ذلك مما يجعل الصحراء بقاعا لائقة للعيش الكريم).
قال: (وينجح هذا العمل إذا تم على مستوى عربى جماعى! فالصحراء العربية برغم ترامى أطرافها إقليم واحد له ميزات ومعالم جغرافية واحدة، ولا صلة لهذه الوحدة بالحدود السياسية الوهمية بين الدول، خطوط الشتات التى مزقت الكيان الواحد).
قال: (أما المطلوب لدراسة الصحراء على المدار الأرضى فهو فى اعتقادى قمر صناعى يرحل إلى الفضاء مع " المتنقل الفضائى " ـ الذى سبق للدكتور الباز اقتراحه ـ يرجع صوره الملتقطة إلى الأرض رواد الفضاء المختارون، وذلك بين آونة وأخرى).
ويكون هذا القمر عربيا فى أغلب نواحيه، يختار مكوناته علماء يقومون بتشغيله، وتدرس المعلومات المرسلة فى عدة معاهد عربية أو فى مركز عربى موحد تشترك فيه الدول العربية كلها).
قال: (وكنموذج للمكونات التى يجب أن يشتمل عليها القمر الصناعى العلمى ينبغى وجود عدة " كاميرات " أهمها " كاميرا " للتصوير الطبوغرافى، و"كاميرا" للتصوير الدقيق، أى بانورامية و " كاميرا " لأخذ الصور المتعددة الأطياف، على نمط أجهزة لاند سات بل أكثر دقة وأقل تعقيدا).
( الكاميرات الطبوغرافية تلزم لأخذ الصور المطلوبة بخرائط على مقياس 1 : 15000 من ارتفاع 180 كيلو متر، وطول عدسة هذه " الكاميرا " هو 305 ملليمترات ومساحة الصورة الواحدة 23 × 46 سنتيمترا.. الخ).
إننى تعمدت هذا النقل ليعلم من يجهل أن دراسة الكون شىء مثير وخطير ولابد منه لدنيانا وديننا معا.
وأن هذه الدراسة برع فيها غيرنا ونبت لديه جيل من الرواد والباحثين العباقرة على حين تراجعنا نحن وراء وراء.
إن هذا التخلف إذا بقى فسوف تتلاشى عقائد الإيمان بالله واليوم الآخر، وينهزم التوحيد هزيمة نكراء.
وإننى لأصرح دون مواربة أن هذا التخلف جريمة دينية لا تقل نكرا عن جرائم الربا والزنا والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وغير ذلك من الكبائر التى ألفنا الترهيب منها. بل لعلها أوخم وأشنع عقبى.
إن الجو الذى يحيا فيه قارئ القرآن يسع البر والبحر، والسماء والأرض، ويطلق الفكر سابحا فى ملكوت لا نهاية له. ويؤكد للإنسان أنه ملك يخدمه كل شىء فما الذى جعل الفكر الدينى يعيش فى قوقعة؟
إننى أحسى فزعا كبيرا عندما أرى بعض المتصدرين فى العلوم الدينية ـ هكذا يوصفون ـ يمارى فى دوران الأرض أو ينكر وصول الإنسان إلى القمر! لماذا؟
لأنه يعيش فى مغارة سحيقة صنعها أشخاص قاصرون، لا يتصلون بحقيقة القرآن إلا كما يتصل القروى بعلوم الذرة.
وإذا كنا هنا قد أطلنا الكلام فى التسامى الروحى للإنسان فلنذكر أن القرآن الكريم ينشد التسامى العقلى والتسامى الخلقى معا.
ويشدد النكير على السقوط الفكرى كما يشدد النكير على السقوط النفسى. أى أنه يحارب الخرافة بالقوة نفسها التى يحارب بها الرذيلة.
بل إن منابع الإيمان فى نفس الإنسان تنبجس مع علم عميق محيط دارس للكون دراسة ملاحظة وتجربة واستقراء لا دراسة تخمين وظنون وخيال..
وإذا لم تنبعث نهضتنا من هذا الأصل فلن تكون نهضة إسلامية صحيحة. إن هذا العلم بالمادة، بالفطرة التى فطر الله الكون عليها، بالسنن التى تحكم هذا الكون علوه وسفله، وطوله وعرضه،
إن هذا العلم ينظم الإنسان مع الملائكة فى الشهادة لله الكبير بالتوحيد والعدل. نعم..
إن أولى العلم، والملأ الأعلى يؤكدون هذه الحقيقة التى شهد الله بها لنفسه فقال: (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم).
----------( يُتَّبع )----------
#محمد_الغزالى #علل_وأدوية
نشر في 08 تموز 2018

تابع
متابع
تابع
متابع
تابع
متابع
تابع
متابع
تابع
متابع
تابع
متابع
تابع
متابع
تابع
متابع
تابع
متابع
تابع
متابع
تابع
متابع

 أديان
أديان علوم
علوم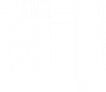 منوع
منوع ثقافة
ثقافة أدبيات
أدبيات تاريخ وجغرافيا
تاريخ وجغرافيا تقني
تقني










